بعد ذيوع خبر اعتقال بوعلام صنصال، كم حاول الفاشست الفرنسيُّون الإعراب عن قلقهم إزاء ذلك، تصدَّر الاسم صفحات وقنوات إعلاميَّة غربية عدة، فرنسية وبريطانيَّة وألمانيَّة، وقلَّدت مشيَتها بعض الصُّحف المغربيَّة، والملفت للانتباه، أن التعبير عن القلق، جاء مرادفًا لصفة أسبغت عليه من دون رقابة فقالوا: الروائي، المثقف، بحثت بالأمس لعلي أجد كتابًا لصنصال، فوقفت له على رواية بعنوان (حراقة) تقع فيما يقارب 400 صفحة، نشرها سنة 2007.
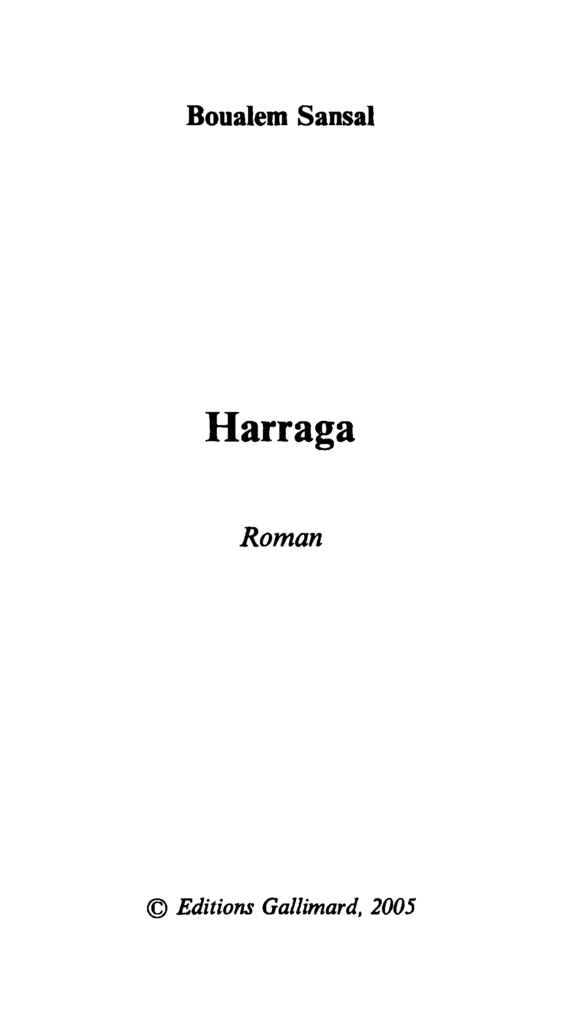
أزمة العمق السردي في رواية بوعلام صنصال
عند قراءة أول سطر من رواية صنصال “لو كانت هذه القصة من وحي الخيال لكانت من أروع القصص” [ص9] يصيبك الشعور بالموت السردي، تتريَّث قليلًا، أكمل الرواية أم لا؟ أهذا راوٍ؟ من المتعسِّر استيعاب رواية تبدأ بحوار مع القارئ في سياق ربط الواقع بالخيال في إطار تبريري، هذا الأسلوب الذي يحاول وضع ثقل الفشل في تكوين عمق سردي مستندًا إلى واقعيَّة القصة “بحذافيرها” [ص9] لا إلى خيال الكاتب، يا له من هزيل!
تبدأ الرِّواية بعبارة “نهارك سعيدٌ أيها العصفور […] واحسرتاه، للعصافير أجنحة” [ص11] أيكون الروائيُّ من اقتات على المستهلك من الرموز، معربًا عند أول صفحة عن مدى افتقاره لإبداع رمزي؟ كتب النقَّاد منذ الثمانينات مؤلفات في انتشار رمزيَّة العصفور للحريَّة في الشعر والنثر، عن أعمال روائية صدرت في الخمسينات والستينات، لتوفيق الحكيم وطه حسين، وميخائيل نعيمة، وغيرهم [1] فهل تكون روايةً منطويةً على إبداع رمزي، تلك التي تغرق في الاستخدام التقليدي؟
في رواية صنصال توجد شخصية رئيسيَّة (لمياء) وشخصية ثانوية (شريفة)، لكن على طول الخط، نجد إفراطًا زائدًا في مظاهر الشخصيات، وتقلُّباتهم النفسية والمزاجيَّة على حساب تقدُّم الأحداث، تحتكر شخصية (لمياء) جلَّ المشاهد، لكن صنصال يمرِّر كل أيديولوجيَّته بشكل مباشر من خلال عباراتها، من دون أي إيحاء أو لغة رمزيَّة، فهو بالكاد يفتقر لإبداع رمزي، فالعوز لخيال أدبي هو ما تدلُّ عليه العبارة المباشرة عند كل فرصة.
ضعف التكامل السردي في تناول قضية الهوية الدينية في رواية “حراقة” لبوعلام صنصال
ومع أن بطء الإيقاع السردي كان سيِّد المشهد، وفي لحظة ما، تستوعب شخصيته (شريفة) أنها حامل، ولا تدري ممن، فتقول “هل هو الرُّوح القدس” [ص69] فهذا ليس سوى تأثر بأفكار سبق وطرحت في أعمال تعرَّضت بالنَّقد للدين المسيحي في (الثقافة الغربية) فما الذي يجعل شخصيَّة جزائريَّة في رواية عن المجتمع الجزائري تعبِّر بشكل ساخر عن الدين مستعملةً أدوات النقد الغربي له؟ فهذه ليست سوى استعارة مبتذلة لهكذا تكلم زاردشت لنيتشه، والإغواء الأخير للمسيح لنيكوس كازنتزاكيس.
إن هذا التوظيف تحديدًا، يحمل أبعادًا نقديَّة مستوحاة من هذا الخطاب، ولكن يوظِّفه في سياق محلي، وهذا غير متَّسق، فالتقليد غير مكتمل، ذلك أن التيارات الغربية التي وظَّفت هذا الرمز، كانت تسعى إلى تحطيم العناصر المقدَّسة مثل الروح القدس، ولكن ضمن مشروع شامل، لا ضمن سياق متناقض لا تشمله فلسفة محدَّدة.
بخلاف نيتشه، ففكرة (موت الإله) والتي هاجم من خلالها الأخلاق المسيحية، كانت لصالح بناء نظام أخلاقي بديل، السوبرمان، الذي تمظهر لاحقا في العرق الآري، وماكسيم غوركي عندما هاجم الأخلاق المسيحيَّة في رواياته، كان لصالح نظام فلسفي شامل، الشيوعيَّة التي تمظهرت في الاتحاد السوفييتي، فرمزيَّة المسيحيَّة واضحة في الثقافة الغربية عند الخطاب بهكذا رموز، فقد كان كل من نيتشه وماكسيم من أبناء واقعهم، ولكن القارئ هنا يتساءل، لمَ تفكر شخصيَّة انحدرت عن خلفية غير مسيحيَّة بمفهوم (الروح القدس) في حين اكتشفت أنها حامل من رجل لا تعرفه، فمثل هذا يضعف تجربة القارئ الذي يمتلك شيئا من المعرفة بالمراجع الأصلية لهذه الأفكار.
والرواية على أيَّة حال تفتقد الترابطَ العضوي، فصنصال يعتمد الإطالة في التعبير عن التشوش الذهني للشخصيَّات خصوصا (لمياء) ويقبع تحت هذه المظلَّة لأكثر من نصف الكتاب، حكايات عن العزلة، وتأمل في الوحدة، إفراط في الوصف وقفز مبالغ فيه على الأحداث، ثم صياغة عبارات مباشِرة لإثبات أيديولوجيَّته–وسيأتي الحديث حول هذا- بخلاف العمل الروائي الجاد. إن كل فكرة يفترض أن تثبت في ذهن القارئ، يجب أن تمر من طريق الأحداث، وعلى سطح نسق جدلي تتفاعل فيه الشخصيات؛ تطفو ضرورة أدبيَّة ما، هي الفكرة التي أراد الكاتب إيصالها، ومع ذلك يفترض أن يتم تقديم الفكرة في قالب مستعار لا أن يباشر بها القرَّاء وإلا أضحى العمل جملة خواطر لا رواية.
الأيديولوجيا المباشرة في رواية “الحراقة” لبوعلام صنصال
يقدِّم صنصال بشكل فج أيديولجيَّته كتعليقات سياسيَّة بدل أن يهتم بتطوُّر الأحداث، كأن يعبِّر بلسان شخصيته (لمياء) قائلا “تبيّن أن الإسلام في الوقت الحاضر صار مسرحية” [ص54] ورغم أن هذا يأتي بعد انتقال عشوائي بين مواضيع مختلفة مثل النِّساء، الدين، المصير الاجتماعي، فهو يطرح قضيَّة كبرى (الدين في المجتمع) بطريقة غير مدمجة في السياق السردي، فنقاش مسألة الهويَّة الدينيَّة، في الرِّواية، لا يكون بهذا الضعف، حيث يجري تكوين مشهد مفاجئ تهجم فيه الشخصية البطلة على الدين وتصفه بمسرحيَّة.
في الأعمال النقديَّة الكبرى، يجري تناول قضيَّة الهويَّة الدينية وفق سياق درامي؛ حيث يتم تشكيل المعنى في وعي القارئ من خلال ما ينطق به الحدث، الأمر الذي يتطلَّب كثافة دراميَّة في شكل صراع بين تيَّارين على الأقل فتتولَّد عنه أحداث ذات حبكة، يتفرَّع عنها معنى بشكل غير مباشر، لا أن يُختصَر كل هذا في طرح أيديولجيا الكاتب كخطاب مباشر على لسان الشخصية في مشهد عابر.
مقارنة بين الطرح السردي لصنصال وألبير كامو
في رواية (الغريب) لألبير كامو، كان مفهوم العبثية، بارزًا من خلال تدفُّق الأحداث التي تطرأ على الشخصية (ميرسو)، وضع أمِّه في دار العجزة، ثم مقابلة حدث موتها بمشاعر متبلِّدة، لم يذرف دمعةً، ولم يشعر بحزن، وأخذ يلاحظ مسائل مثل الحر والشمس، منفصلًا عن كل المشاعر الإنسانية التقليدية، ثم اللقاء بصديقة قديمة (ماري) وإقامة علاقة حميميَّة معها بعد وفاة الأم مباشرة، دون أي اعتبار للنَّوازع العاطفية العميقة، ودون الشعور بأي تناقض بين المأساة المفترضة تجاه والدته، وبين متعته الآنيَّة، وهكذا يطبع ألبير كامو في وعي القارئ أن ما يحدث في الحياة من قضايا كبرى، من الفقد إلى الحب يجري التعامل معه بنفس اللامبلاة، فكل شيء بنظره غير مهم في النهاية.
لكن كامو، يستخدم الأحداث كروائي، ليُظهِر العبثية في صورة عالم غير منطقي تعيشه الشخصيَّة البطلة، تعيشه، لا تتكلَّمه، فلم يجري التعبير بلغة متسرِّعة عن هذا المعنى مباشرة، فرواية (الغريب) لا تنطوي على عبارات من قبيل (محاولة الإنسان لإيجاد معنى دائم وقيم ثابتة أمر لا جدوى منه) بل هذا مما ينطبع في ذائقة القارئ من خلال العمق السردي.
الحرية بين المعالجة السردية والتعبير المباشر
وحين يبشِّر كامو بالتَّمرد على القيم الاجتماعية من خلال تدفُّق درامي في روايته، لا تجد لديه تلك العبارات المتسرِّعة كالتي عبَّر بها صنصال عندما أراد بثَّ معنى التَّمرُّد في روح القارئ، فأخذ يتكلم بمباشرة فجَّة معه قائلا على لسان الشَّخصيَّة أنها أعلنت “التمرُّد المستميت على الأشباح التي تقاسمها أسرار الزمن الغابر” [ص31] فالتمرُّد هنا غير مبرَّر سرديًا، فهو شعور قد تولَّد لدى الشَّخصيَّة على خلفيَّة (أسرار الزمن الغابر) وهو ما نجهله على طول خط الرواية، ولم يكلِّف الكاتب نفسه عناء إضفاء بعد رمزي لطبيعة هذه الأسرار، فقط يريد أن يوضح أن شخصيَّته الأنثى قد تمرَّدت، وهكذا يكلِّفنا تمعُّن خواطره الأيديولوجيَّة قبل الرِّواية!
وفي حين نستوعب مفهوم (الحرية) من خلال رواية كامو على أنها وليدة الشعور بعبثيَّة الحياة فلمَ التقيُّد بقيم ما عند أحداث حياتيَّة كبرى كالموت والحب؟ لا نجد على لسان الشخصيَّة مرافعة ساذجة عن الحرية، فالرواية تشرح الحرية كما لو أنها سيِّدة الأحداث، تدفع بالسرد إلى الأمام ليخدم الحبكة، بدل أن تجمِّده لصالح التعبير اللحظي على لسان الشخصية. وهكذا، يتداعى صنصال بحمل شخصيَّته مشعل الحريَّة.
ولكن لا أحداث في الموضوع، بل يقابل القرَّاء باستخفاف، وكأنه قائلٌ لهم: لستم أهلا لاستنباط المعنى من الوقائع، فهو يلقن القارئ على لسان شخصيَّته “علينا أن نمنح شبابنا الحريَّة” [ص161] وأي حريَّة؟ تلك التي أنف تسميتها على لسان الشخصيَّة “الهجرية السرية، إن العبارة الصحيحة هي النزوح المكثَّف” [ص161] فأي تشويق بقي للظفر بمعنى؟ فمع أنَّ الكاتب يحمل جنسية فرنسيَّة، إلا أن أعمدة الأدب الفرنسي لم يؤثوا في ذائقته بشيء على ما يبدو.
تغذية النزعة الانهزامية في رواية بوعلام صنصال
يهجم صنصال على لسان شخصيَّته بشكل مباشر على الجزائر، واصفًا مدينة العاصمة “بأنها نموذج للانحطاط الأبدي” [ص76] فهل يكتفي بهذا؟ يتعرَّض بشكل مباشر إلى ضرب مفهوم (الشعب) معتبرًا الواقفين داخل المحطَّة “حشدًا هائلا وكأنَّ حشود العالم كلَّه تنزل فيها، زوَّاداتهم على أكتافهم ورؤوسهم مطأطأة، يمشون وهم وجوم، وحالتهم تدعو للرِّثاء […] تراهم كأنَّهم خارجون لتوِّهم من محتشدات الغولاغ للأعمال الشاقة في الاتحاد السوفييتي، ولا ينتظرون إلا صافرة الإنذار للعودة إليها” [ص76]

صنصال هنا، يوصِّف العاصمة الجزائر على أنَّها سجن، أو محتشد، لا يأوي شعبًا، وإنَّما مساجين يخضعون لشبكة معسكرات للعمل القسري، كتلك التي أنشئت في عهد ستالين (الغولاغ)، والتي كانت تدار من قبل جهاز الأمن السوفييتي، تحتجز السجناء السياسيين والمدنيين، وتجبرهم على العمل الشاق كالتَّعدين وقطع الأخشاب تحت ظروف قاسية كنقص الطعام، وبرودة الطقس، وانعدام الرعاية الطبية.
والنص هنا لا يعاني أزمة في الإيقاع السردي فحسب، حيث التأرجح بين الإفراط وبين القفز المفاجئ على الأحداث، بل إنَّ السرد يتمحور على الوصف الثابت والمجرَّد للحشود، دون إضفاء أي حركة سردية تجعل المشهد حيويًا، فيرهق النص ببث رؤية تشاؤميَّة مباشرة عبر تغذية النزعة الانهزاميَّة دون توجيه السرد إلى أعماق الطبقات ونوازعهم، فالسرد ميِّت لصالح الانحياز، والتعقيدات الواقعية في المشهد ميتة لصالح الانغلاق.
غياب الصراع والحركية في السرد الروائي
الرواية تبدو تمجيدًا مباشرًا لفكرة العجز والانهزاميَّة، التي جرى تصويرها كأمر محتوم، فالملاذ في عنوان الرواية (الحرقة) أي الاغتراب نحو فرنسا، وهي حالة صنصال الذاتية، وإلا فإن إعادة إنتاج صورة الحشود الكئيبة والمقهورة بشكل نمطي دون أي محاولة لتقديم تحليل يكشف أعماق النوازع الطبقيَّة، يعكس نوازع تنفي قدرة الشخصيات على مواجهة أي تحدٍ وكأنَّه يصورِّر للقارئ أن الجزائر ليست الحياة فيها سوى سلسلة من الإخفاقات المتكررة بلا أفق في السرد.
هو يضطر القارئ للشعور بعار جماعي لكونه جزائريًا، يضطره لانفصال عن هويَّته، من خلال مظاهر البؤس، ولكن جدليَّة الأسباب والنتائج عند الحديث عن (بؤس الواقع) تبدو منعدمة على طول الرواية، فلا مساحة لفكرة مقاومة، أو أمل كبديل عن حالة مزرية ينسجها، فالشخصيات تبدو كأشباح بدون إرادة، تتلقى الأذى والمصاعب، دون أي محاولة لتصدِّيها.
وما دام الصِّراع هو روح أي عمل سردي، فوجوده في الرواية هو بين الوجود في الجزائر، بين الوجود في فرنسا، (الحرقة) تلك التي يبديها الكاتب ضرورةً نفسيَّة ملحَّة للخلاص، بدل التغيير، وهو نفس المنزع الذي رام سلوكه ثلة من الجزائريين إبان الاستعمار بجعل الذوبان في فرنسا هو ضرورة لانتشال العنصر الجزائري، فالروايةَّ ليست مشبعة بالانهزاميَّة وحسب، بل تقدمها كرسالة وحيدة.
الرواية كوسيلة لتبرير الذوبان في الهوية الفرنسية
رواية (الحرقة) لصنصال، لم تفلح على الأغلب في تكوين دافع (الحرقة) لدى قارئ واحد، فعلى ما فيها من انكسار في الكاتب، إلا أنَّها تفشل في ذلك لغياب الدافع الحركي والشعوري، هي رواية انهزاميَّة بالنسبة لجزائري، ولا تعدو أن تكون تعبيرًا ركيكًا عن مبررات صنصال لأن يكون فرنسيًا ذو خلفية جزائرية، وأي رواية تتحدَّث عن التحرر نحو فرنسا، تلك التي ينتهي المطاف بمؤلفها إلى بيدق بين يدي اليمين الفرنسي، فكريًا وأيديولوجيًا، وسياسيًا، بدل أن يكون فاعلًا في واقعه.
- أنظر: العناصر الرمزية في القصة القصيرة، فاطمة موافي، 1984، ص213 ↩︎

اترك تعليقاً