كتاب نشأة النظام الأبوي تأليف غيردا ليرنر، هو كتاب جد مركزي ومهم في فهم الأيديولوجية النسوية، واستيعاب الأنساق العميقة والواسعة لمختلف دراساتها وقراءاتها التاريخية، لا أنصح به المبتدئ في دراسة الأنساق النسوية، ولا لمن لا يعرف شيئا في نظرية المعرفة.
المحتويات
3 ساعات: مراجعتي الصوتية لكتاب نشأة النظام الأبوي
نشأة النظام الأبوي كطاولة تشريح
طرحت غيردا ليرنر في نشأة النظام الأبوي أسس الأيديولوجية النسوية للسردية التي ترى من طريقها المنظومة الأبوية الباترياركية، الأمر الذي سيجعل مهمة المقارنة مع تلك الأطروحات النسوية الإسلامية أقرب لضبط آلية الاستنساخ والتوفيد، فمثلا تطرح غيردا ليرنر أنه قد “شكلت الدول القديمة في شكل نظام أبوي”1 و”تمأسس الخضوع الجنسي للنساء في الشرائع القانونية الأسبق” 2 “تم تأمين تعاون المرأة في النظام عبر وسائل مختلفة: القوة، الاتكال الاقتصادي على رب الأسرة الذكر” 3
فهذا يُشعرك لوهلة أن الدول الحديثة مؤسسة وفقا لثنائية الذكر والأنثى، كتقدمية معتبرة تجاه النساء، في حين أن القراءة السياسية للأجهزة المدنية تثبت امتداد شكل الدولة الأبوية القديمة، فمثلا “المرأة في فرنسا لا تشغل إلا ٧٪ من الفضاء السياسي الفرنسي” 4 “وهكذا فالجهاز المدني السياسي يتم تشكيله وفقا لصورة الفرد الذكر الذي يتكون عن طريق فصل المجتمع المدني عن النساء” 5 “وبالتالي فإن منح حق المواطنة للمرأة يثير مشكلة ما إذا كان يجب على المرأة باعتبارها مواطنا، باعتبارها عضوا في المجال العام، أن تتخذ هوية ذكورية وتتكلم لغة العقل الذكوري” 6
إعادة قراءة التاريخ في نشأة النظام الأبوي
ولهذا جرى لدى كثير من الإسلاميات، مثل هبة رؤوف عزت الاستلهام من مقدمة إعادة قراءة التاريخ، لتجاوز اتخاذ الدولة شكل النظام الأبوي، فلكي تكون المرأة خليفة للمسلمين، يجب إعادة قراءة وتأويل: الفقه، الإجماع، الأحاديث، لتجاوز فكرة خضوع النساء في الشرائع القانونية السابقة، وعليه فقد نظرن النسوية إلى ضرورة التاريخ، فجاء في كتاب غيردا ليرنر: “إن تاريخ النساء أساسي وجوهري لتحررهن” 7 “إن النساء قد شاركن العالم دوما وعملن هن والرجال أيضا بشكل متساو” 8
“ما فعلته النساء وجربنه ترك من دون تدوين وأهمل وتم تجاهله في التفسير” 9 و”أبعدت النساء عن الإسهام في صناعة التاريخ، أي من ترتيب وتأويل ماضي البشرية” 10 “فالنساء هن الغالبية، ورغم ذلك صُنِّفن في المؤسسات الاجتماعية كما لو كُنَّ قلة” 11 “النساء صنعن التاريخ، إلا أنهن أبعدن عن معرفة تاريخهن وعن تأويل التاريخ، سواء كان تاريخهن أو تاريخ الرجال” 12 “تم إقصاء النساء على نحو ممنهج من مشروع إنشاء الأنظمة الرمزية، والفلسفات والعلم والقانون ولم تُحرم النساء من التعليم عبر التاريخ في المجتمعات المعروفة كلها فحسب، وإنما استبعدن أيضا عن صياغة النظرية” 13

بالتالي فهي تعتبر أن التقليديين قد تجاهلوا “التغيرات التكنولوجية، التي مكنت من تغذية الأطفال بالزجاجات بأمان، وأوصلتهم إلى سن البلوغ مع مربيات غير أمهاتهم، يتجاهلون المعاني الضمنية لتغيير مدة الحياة وتغيير دورات الحياة، وقبل أن يقوم علم الصحة الجماهيري، والمعرفة الطبية الحديثة بالحد من وفيات الأطفال إلى مستوى مكن الآباء والأمهات من أن يتوقعوا على نحو معقول أن كل طفل يولد لهم سيعيش إلى سن البلوغ، [قديما] كان على النساء أن ينجبن الكثير من الأطفال، لكي يبقى على قيد الحياة قلة منهم” 14
مقالة الأمومة بين النسوية والإسلامية
“إن الزعم بأن رعاية المرأة [رعايتها لأولادها/ لم تقل: أمومة] هي الوحيدة بين الأنشطة البشرية كلها، التي تعد غير متغيرة وأبدية [تُنبِّه على أن التقنية الحديثة: يجب أن تغيّر من أدوار النساء]، يعني أننا ندفع بنصف السلالة البشرية إلى حالة أدنى من الوجود” 15
فالطريف أن كثيرا من الناس يفترضون، أن مقالة الأمومة وما تعلق بها من فضائل تحقق الكفاية في نقد الأيديولوجيا النسوية عند دعاية [تدني وظائف المرأة]، وهذا لحظته مرارا في صوتيات ومقاطع وكتابات، لكنه يدل على ضعف علم المتكلم بالأفكار الأساسية في ذي المدرسة، إذ أن هذه الحجة، تعبر لديهم عن مقدمة بيولوجية متجاوزة بفضل التقنية، ولا يطلبن -أصلا- التذكير بفضائل المرأة الأم، إذ يرينه عبارة عن وسيلة لتقويض المهمات المركزية في صناعة التاريخ، والإبقاء على المرأة ضمن دور ثانوي.
وهذا النوع من الخطاب -لا يرقى ليكون نقدًا- هو يعمل بصورة فجة على تكريس تشويه العلوم والأفكار باستحداث وعي مشوه تجاه المقالات النسوية، يدوم لسنين، ثم يجاب عليه بكلمة: أنت لا تعرف النسوية ما هي أصلا، تقول ليرنر “والآن بعد أن أنشأ الرجال أمة جديدة، أوكلوا إلى النساء الدور الجديد «أم الجمهورية»، المسؤولة عن تنشئة مواطنين سيقودون المجتمع، الآن ستتمتَّع النساء الجمهوريات بالسيادة في المجال العائلي كما يطالب الرجال بحزم أكبر، بما لي ذلك الحياة الاقتصادية، كمجالهن الحصري.
صارت الأجواء المنفصلة المحددة جنسيًا والمعرّفة في عبادة الأنوثة الحقيقية، هي الأيديولوجيا السائدة، وحين مأسس الرجال هيمنتهم في الاقتصاد، والتعليم، والسياسة، شُجِّعَت النساء على التكيُّف مع وضعهن كخاضعات بأيديولوجيا منحت وظيفتهن الأمومية أهمية عالية
وبينما قبلت المناضلات النسويات الأوائل وجود مجالات منفصلة كحقيقة مقررة، حولن معنى هذا المفهوم بمناقشة أن من حق المرأة وواجبها دخول المجال العام، بسبب تفوق قيمتها والقوة المتضمنة في دورها الأمومي” 16
عبادة النساء تاريخيا
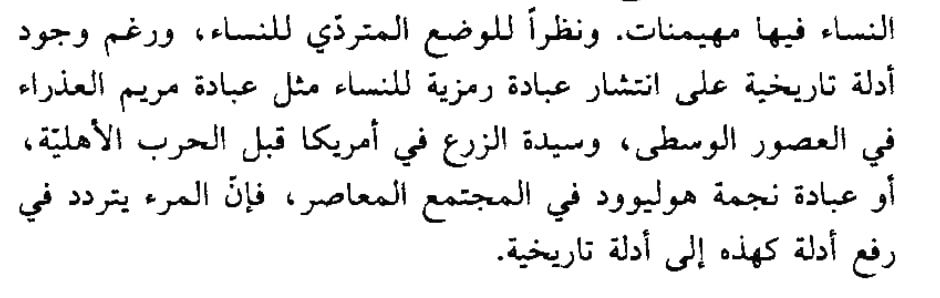
هو عبارة عن تخمين: هل يرقى هذا التاريخ لإثبات هيمنة النساء على الرجال؟ تتردد ليرنر في الإجابة، يمكن أن تضيف إدعاء سجاح بنت الحارث للنبوة ضمن أعظم محاولات الهيمنة النسائية في التاريخ العربي، بل مثلت شطرًا من الهيمنة -وفقًا للتحليل النسوي- إذ تبعها قوم من بني تميم، وقوم من بني تغلب، وكان الخاضعون لها من رجال الجيش يبلغون: أربعين ألفًا.
الاستنساخ أين يكمن؟ الأيديولوجيا النسوية تركز على الحفر التاريخي لإعادة التأويل، لذلك كل القراءات التي تأتي في سياق البحث عن المحطات التاريخية للهيمنة، وما تفرع عنها كالمشاركة المساواتية في المجال العام، تحت أي مسمى في المتعارف الإسلامي، هي عبارة عن قراءة تستنسخ نفس الأداة الأيديولوجية.
إشكاليات النظام الأمومي
إشكاليات مدرسة النظام الأمومي النسوية، لا تكاد تجد لها ذكرًا في الأوساط النقدية الإسلامية، وهي تعبر عن حلقة وصل أساسية بين وهم «سلطة المرأة» وبين طلب السلطة الفعلية نسويًا، يلعب ترويج علو منزلة الأم كوسيلة سلطة على الرجال -كما في نظرية باشوفن عبر كتاب: النظام الأمومي، التي أثرت في كل من أنجلز، وشارلوت (ليرنر)- أواخر ١٨٠٠ على تكوين حشد واسع من دعاة الحركة النسوية يسلِّم بـ «سلطة المرأة» بناء على تأكيد المنزلة العليا للأم.
والآن لدينا شق من الإسلاميين اليوم، يركزون على المنزلة العليا للمرأة في صورة الأم مقابل المزاعم النسوية التي تقول بتدني المرأة، هل وقع التعاطي النقدي والتمحيصي لمدرسة باشوفن؟ لا، يتقدم الإسلاميون فيما يسمونه نقدًا، مع أنهم يقدمون مادةً تعبر عن معرفة ضرورية في المدرسة النسوية الأمريكية منذ ١٨٠٠، منزلة الأم العليا.
مع تقدم النقد النسوي قليلًا، على الأقل حتى ١٩٧٤، ما التحليل الذي صار معتمدًا تجاه نظام الأمومة؟ تقدم الفكر النسوي مسافة قرن، وصار يرى أن: “المجتمع الذي تتمتع فيه النساء بمنزلة عليا نسبيًا: لا معنى له كفئة” 17 ولا يمثل النظام الأمومي “تمكينًا صادقًا إلا في حين تسيطر النساء على السلطة ويحكمن الرجال” 18 فإنه “لا تعني المنزلة الرفيعة للنساء السلطة بالضرورة” 19 فالأمومة ضمن الأدبيات النسوية عام إبان ١٩٧٤ مثلا، كما تقول ميشيل روسلو:
“حتى في حالات تملك النسوة قوة شكلية، فإنهن لا يمتلكن سلطة” 20 “كان للنساء مواقع مهمة وكن في مجلس الوجهاء، ولكن لا أحد يستطيع أن يشغل منصب الرئاسة سوى الرجال” 21 وبالتالي، أضحى منذ عشرات السنين -كما هو مكرس في الكتابات النسوية- نظام الأمومة -المنزلة العالية للأم-، وسيلة لتقويض السلطة الفعلية للمرأة. مع هذا، وهناك كتابات معاصرة لمن يعيشون أبَّهة الزعامة في مثل ذي الموضوعات، يكتبون، ويتكلمون، في الرد على “الأيديولوجية النسوية”، وهم يثيرون إشكاليات بدائية جرى فحصها ونقدها مرارا في المدرسة النسوية.
وهنا تنبيه على شذرة نسوية؛ من الأمور المؤكدة لدى ليرنر، وأوسلو، أن تصدير خطاب السلطة (الوهمية) للمرأة الأم في مجابهة النسوية، سيمدد فترة اللانسوية الذكية فقط، إذ هو في النهاية لا يساهم في تأكيد السلطة الفعلية لهن، بقدر ما يساهم لاحقا في “التمادي” نحو المناصب السلطوية الفعلية، سواء في الشأن العام أو الخاص، كالولاية، الإمامة، الإمامة الكبرى، الجهاد، القوامة، القضاء، ونحو ذلك، وهذا ما تلحظه في كتابات هبة رؤوف عزت، وبعض من تفرع عنها على خجل.
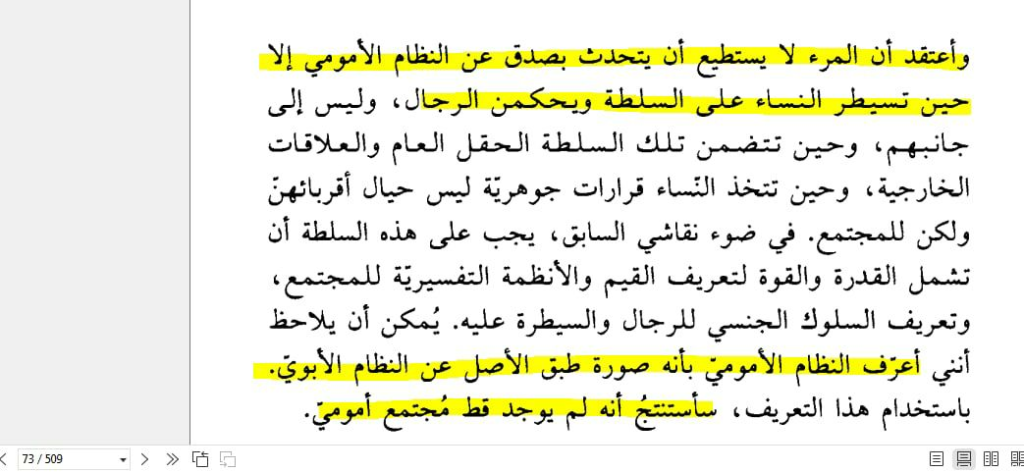
المشكلة لا تكمن في بحث حيثيات النظام الأمومي، بقدر ما تكمن في الكتابات الإسلامية التي تنطلق من نفس أفكار النسوية بعد كتاب باشوفن. كيف ذلك؟ تعتمد الأدلجة النسوية إعادة اعتبار النساء في المجال العام، بناء على محطات النساء الفطرية في التاريخ القديم، بكونهن كن يمثلن سلطة تجابه السلطة الأبوية «الذكرية»، أطلق عليها اسم «النظام الأمومي» ذي السلطة النسائية.
تقوم فكرة النظام الأمومي، على أنه تاريخيًا، يوجد دلائل على ثبوت «السلطة الفعلية للنساء» بناء على أنهن أمهات، فمكانتهن العالية، تعبر عن نوع سلطة نسائية، ولأجل تمكين النساء في المجال العام اليوم، يجب إعادة توطيد ذلك التاريخ باعتباره مرجعية ركيزة للانطلاق في تكوين نظام أمومي معاصر، يقارع النظام الأبوي.
هذه هي الحجة النسوية التي جاء بها باشوفن، وكان لها أثر على أنجلز في كتاب أصل العائلة، حتى انفجرت كنظرية عامة للنسوية الأمريكية أواخر ١٨٠٠. ثم تقدم الوعي النسوي، فأدرك أن النظام الأمومي لم يكن له أي وجود تاريخي، فالمنزلة الرفيعة للأم تاريخيًا، لم تمكِّنها من أي سلطة فعلية تقود بها الرجال.
ماذا يفعله كثير من الإسلاميين؟ النسوية تقول بعدم وجود تمكين سلطوي للنساء، وهذا خطأ، يجيب الإسلامي – غير مدرك- بنفس الحجة النسوية: إن مكانة الأم عظيمة في الإسلام، تسأل النسوية: هل هذه المكانة تساهم في تنشئة نظام سياسي واجتماعي وأسري غير أبوي؟، يعود الإسلامي: الأم منزلتها عظيمة في الإسلام. وقد كان أحدهم يكتب في الرد على النسوية مستعملًا نفس الحجة النسوية لباشوفن “هل وجدتم من هؤلاء المشككين أحدًا يذكر مكانة الأم، التي حظيت في الإسلام بمنزلة لا يمكن أن تحظى بها في أنظمة الدنيا”. هذه إعادة استنساخ حرفية للأداة.
بين نشأة النظام الأنبوي والنسوية الإسلامية
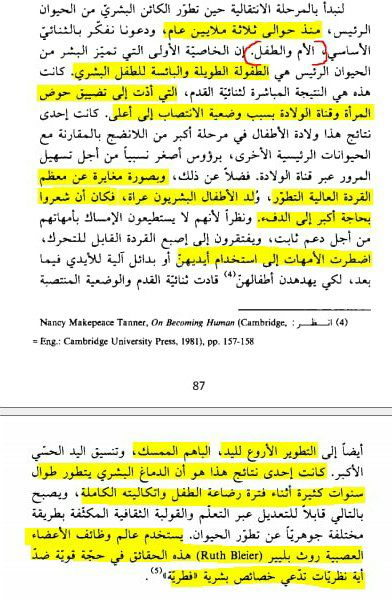
أي ورقة تنطوي -بأي صياغة سواء لبقة أو فجة- على فكرة تأثر الصحابة، أو الفقهاء عموما بـ “مجتمعهم” في آرائهم حول جنس النساء؛ هي فكرة تطورية في الأساس، وجدت سبيلا ما، ولحقت لأفواه وأقلام السذّج، ذي الفكرة تعبر عن أنجع أداة في النظرية النسوية، تعتمد على نتائج علم وظائف الأعضاء العصبية التطوري ثم قراءتها وفق علم الاجتماع الماركسي، وهي تعبر عن “حجة قوية ضد أية نظريات تدَّعي خصائص بشرية فطرية” 22
مثلًا، عند إنجاب الأم غير المتطورة لأطفال، فإن الطفل يختلف عن القرد من حيث حاجته إلى الدفء فهو بلا شعر، الأمر الذي سيساهم في تطوير قابلية الانشغال المتزايد بالطفل وقلة الحركة خارج المجتمع، إضافة إلى تطور اليد ليتم استخدامها لهدهدة الطفل، مما يؤدي إلى “تطوير أروع لليد، الباهم الممسك، وتنسيق اليد الحسي الأكبر” 23
ما النتيجة؟ “الدماغ البشري يتطور طوال سنوات كثيرة أثناء فترة رضاعة الطفل واتكاليته الكاملة” 24 تأتي وظيفة علم الاجتماع الماركسي في أن العلم المثبِت لـ “لافطرية الخصائص البشرية الأنثوية”، وبالتالي تفوُّق النظام الأبوي بناء على تلك اللا فطرية، فإن الأديان التي نشأت ضمن علاقات المجتمع هذه 25 تمت صياغتها وفقًا لذهنية الذكر، أي دين ذو نظام أبوي، الذي لا يعير الوظائف ما قبل التطورية للمرأة أي اهتمام، بناء على ما أورثته العلاقات الاجتماعية تلك.
العلاقات الاجتماعية، هي المؤثر الركيز، فلا توجد حينئذ فطرية وظيفية، بل لوح فارغ على مستوى الوظائف والخصائص الجنسية. إن الفقيه وفقا لهذا، يقوم بإنشاء دين، أو فقه، مبني حصرًا على المنظومة الاجتماعية الأبوية التي تسببت في تكريسها الوظائف التطورية للمرأة الأم، والتي سمحت بتمكنه اجتماعيا دونها، فأنتج نمط دين متجه لنصرة الأبوية بدلًا عن الأمومية.
والظروف النفسية التي تمر بها الأم في فترات الولادة تلك تساهم أيضًا في تقويض قدراتها الفطرية (كمال العقل، الرأي، القوة النفسية، الاهتمام بالأشياء) لكثرة انشغالها عن المجال العام، فتكون العبارات التي من قبيل ضعف العقل مقارنة بعقل الرجل، ما هي إلا تقعيدات مبنية على أثر العلاقات الاجتماعية التي أنتجها تطوّر الأم على اللوح الفارغ. مهما تغيرت الصياغات، فهذا هو مدار أي ورقة تحكي عن تأثر الفقيه بمجتمعه.
شيوع الأسس النسوية في الكتابات الإسلامية
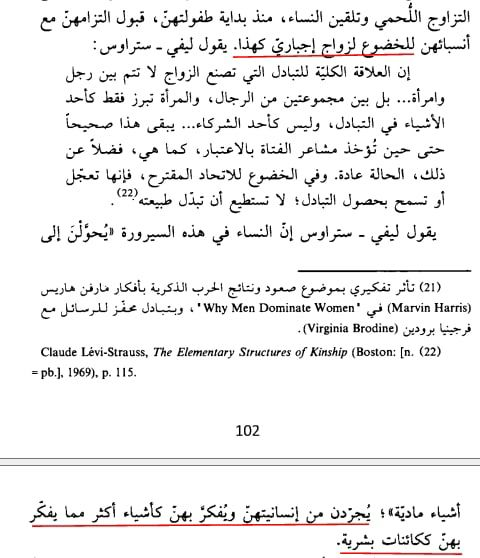
من الأسس في الدراسة النسوية، ما شاع في كثير من الكتابات الإسلامية، من أنه يجب أن “نفكر بالجندرة تاريخيًا” 26 وهي الفكرة التي كان ماري بيرد أول من قدم لها صياغة نظرية. لقد سلطت الدراسات النسوية حول نشأة النظام الأبوي، الضوء على تاريخ الزواج الإجباري، وتم تقديم كثير من القراءات لذا التاريخ.
كان بينها أطروحة إليزابيث فيشر،التي ترى أن تطور المجتمع إقتصاديًا نحو تدجين الحيوانات، علم الرجال أدوارهم في التناسل، حيث تعلموا من الحيوانات فكرة التزاوج الإكراهي، ليطوروا السلوك البشري نحو نحو اغتصاب النساء. “زعمت فيشر أن الوحشية والعنف المرتبطين بتدجين الحيوانات، قادا إلى هيمنة الرجال الجنسية، ومأسسا العنف” 27
طُورت الدراسات بصورة نقدية في الأبحاث الجندرية، إلى حين ١٩٦٩، مع ليفي ستراوس، وتم طرح أن فكرة الاغتصاب تلك، التي هي أساسا تعبر عن إكراه جرى تطويره من إكراه مجتمعي على إغتصاب، إلى إكراه مجتمعي على «الزواج الإجباري». الزواج الإجباري، يؤكد البحث النسوي لستراوس، أنه يقوم على تطور اجتماعي محض تنشأ في إطاره ذي العلاقات الاجتماعية، فهل يكفي رفض الزواج الإجباري-الإكراهي في القول بأن المرأة خرجت عن دائرة الإهانة؟
يؤكد محمد الغزالي على نشوء جانب من الفقه في موضوع الزواج، على مخرجات الطرح النسوي، عند قوله “إن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره!!، لا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصها” 28 مع ملاحظة أن الغزالي -بطريقة ما- يستنسخ نفس قالب القراءة النسوية للفقه، إلا أن هذا الترقيع لا يخرجه عن معاملة المرأة بصورة مهينة، وفقا لتلك المقدامات.
إن الزواج ككل، سواء كان إكراهيًا أو غير إكراهي، يبقى في نقطة وجوب وجود الولي، وأن المرأة لا تلي نفسها في الزواج حتى مع اعتبار مشاعرها وموافقتها، يدخل في حيز كونها “أحد الأشياء في التبادل، وليس كأحد الشركاء، ويبقى هذا صحيحًا حتى حين تؤخذ مشاعر الفتاة بالاعتبار” 29 وتبقى النساء حتى في حالة كهذه، مع التحاكم للغة «تحقير شخصها» “مجردة عن إنسانيتها، ويفكر بها كأشياء، أكثر مما يفكر بها ككائن بشري” 30 فهي تحولت وفقا لنسق الغزالي من «تحقير شديد» إلى «تحقير أخف».
الفقه في نظر النسوية الإسلامية
فمع قراءة الفقه جندريًا لدى الغزالي، لا يلاحَظ أنه قدم اعتبارًا للمرأة وفق تصوره، بقدر ما أكد على ضرورة “التفكير بالجندرة تاريخيًا”. لذا، يلعب الطرد دورًا هاما، إذا ما توسعت قراءة الغزالي لتشمل أحاديثًا من قبيل “لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها- لا نكاح إلا بولي- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل!
فنكاحها باطل “لهذا كانت هبة رؤوف عزت، ترى في رسالة «المرأة والاجتهاد» أن الغزالي، من بين الشخصيات التي قدمت الكثير للمرأة وأنصفها من الفقه الذي يُكبِّلُها، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة «التجديد المتكامل» في هذا الملف.

التجريد ثم البناء
الجزء الأول والثاني من الكتاب، قدم كل القراءات النسوية المعتمدة لنشأة النظام الأبوي تاريخيًا، لديك مجتمع، فيه نساء ورجال، سيطر الرجال وفقًا لسرديات معينة على النساء وقاموا بإخضاعهن، هذه هي القاعدة المجردة من مختلف تلك القراءات المعتمدة، وهي تعبر -وفقا لأي صياغة- عن أيديولوجيا نسوية.
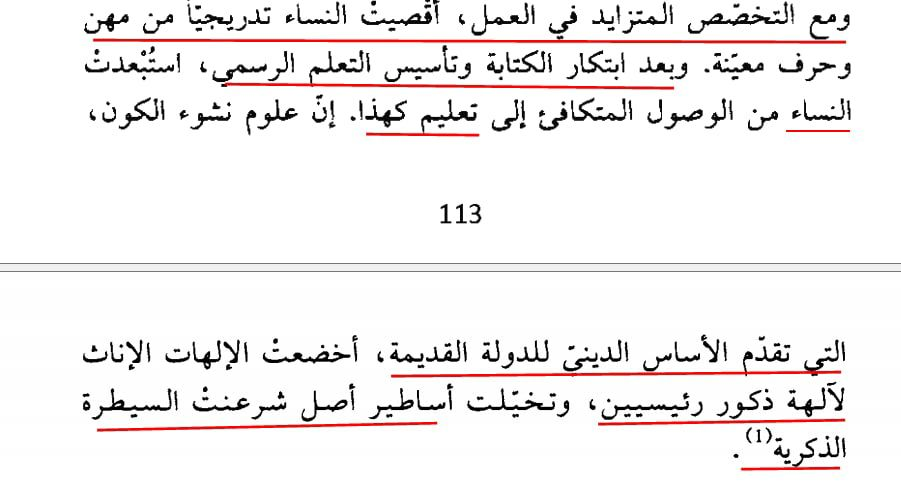
هذا النص المرفق يتحدث عن النموذج شبه النهائي من النظام الأبوي المحكم، الآن كيف تأتي القراءات المؤدلجة نسويًا للتاريخ الإسلامي؟
- أطروحة نسوية أعم: المرأة كانت مساوية للرجل، حتى جرى الإقصاء التدريجي لها، ثم توصل المجتمع إلى ابتكار نمط تعلم، فأقصيت عنه النساء مما ساهم في تأكيد خضوعهن، وعلى هذا سارت الأديان، بعد إقصاء عبادة الإلهات.
- أطروحة نسوية أخص: سجاح الموصلية، تعبر في الطرح النسوي الراديكالي العربي 31 عن امرأة جاءت في فترة تم فيها ابتكار دين، كانت فيه النساء مستبعدة عن أصل الإبتكار، أي تمظهر النبوة فيها، فثارت سجاح على هذه المنظومة الأبوية، وحاولت أن تتمرد على المجتمع بإعادة الاعتبار للمرأة النبية. إلا أنها قوتلت، ثم جرد فقهاء المسلمين أن جنس النساء لا يكون فيه نبية.
- الطرح النسوي الإسلامي الصريح: مع التخصص المتزايد في علوم الشريعة، أقصيت النساء عن علوم معينة، فبعد ابتكار علم الحديث مثلًا، أستبعدت النساء عن الوصول المتكافئ إلى تعليم كهذا، وهنا تأتي سرديتان: سفيان الثوري: «علم الحديث ذكر يحبه الذكور»/ فرع فقهي: «لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، الحديث تلزم منه الرحلة لأجل طلبه»، ولأجل مركزية الحديث وعلومه/أهل الحديث، أقصيت النساء عن الريادة في العلوم الدينية، وتم إخضاع العالمات النساء للعلماء الذكور، فلم ينتج التاريخ الإسلامي أصوليّات، ولا عالمات جرح وتعديل، ولا مجتهدات في الفقه، فضلًا عن مفسّرات للنص الديني سواء قرآني أو حديثي.
- الطرح النسوي الإسلامي الخجول، يدور كله حول مقولة: تأثرَ الفقيه، والعالم، ورجل الدين المسلم، بمؤثرات اجتماعية في أحيان كثيرة، وهي ما يفسر بعض أقواله الفقهية أو الأدبية أو التفسيرية الإخضاعية، تجاه النساء، ولذلك نلاحظ التناقص الرهيب في الإسهام العلمي للنساء، بعد العصر النبوي.
في استخدام النسوية للشرائع كمصدر للتحليل التاريخي
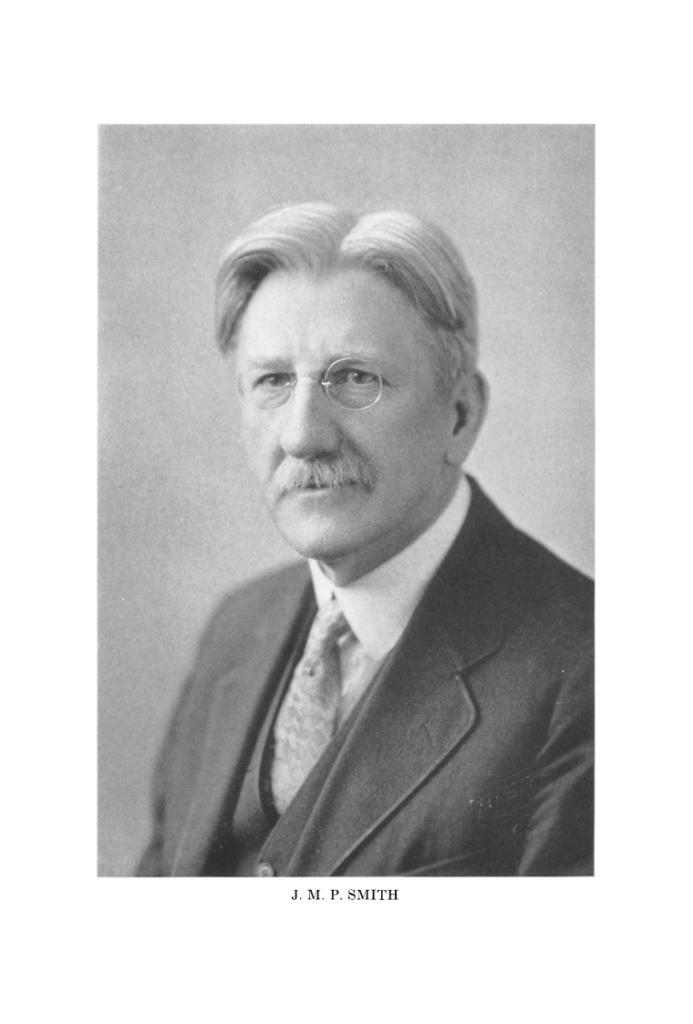
عند استخدام الشرائع كمصادر للتحليل التاريخي “نفترض أن القوانين تعكس أوضاعا اجتماعية بطريقة محددة جدًا” 32 وهذا ما عبر عنه بويس سميث قائلا: “يمكن القول، عمومًا، إن التشريع يسبق أوضاع الحياة التي يهدف إلى التعامل معها، ولكنه ينشأ من أوضاع ومواقف موجودة فعليا يهدف إلى توجيهها والسيطرة عليها” 33
“يشير القانون دوما إلى أن الممارسة التي يُعلّق عليها، أو التي يشرِّعُ من أجلها، موجودة وصارت إشكالية في المجتمع” 34 هنا تتحول قراءة التاريخ التشريعي -أيًا كان- بجعل الظرف الاجتماعي المساهم الحصري في تشكيل التشريع. فإذا كان لدينا فرع فقهي، أو نص أدبي لمتشرِّع، يعتبِر سلوكا أنثويًا أو جنسيًا؛ قبيحًا أو حسنًا، فالأدلجة النسوية تضعك أمام احتمالين “هذا السلوك إما أنه كان موجودا، أو أنه صار إشكالية في المجتمع”35
على كل الأحوال، يلعب المجتمع، أو العلاقة الاجتماعية، حتى الأسرية منها، دورًا ركيزًا في إنشاء الإلزام التشريعي، أو النص الأدبي لمتشرع ما. وهذه النظرية لاقت ازدهارا في الكتابات الاستشراقية حول نشوء علم الحديث مثلا، وهو تحليل خاضع عموما لعلم الاجتماع الماركسي حول نشوء الدين، حتى ثم تحويله لأنجع أداة نسوية في قراءة الدين تاريخيا.
فالقانون الفقهي وفقا لهذا النسق لا ينشأ بعد النظر في دلالة النص، ولا بعد تأمل سليم في الخصائص البشرية الفطرية سواء ذكرية أو نسائية، وإنما مداره على مركزية تأثير العلاقة الاجتماعية. وهذا النسق المعرفي، واسع جدًا ويستوعب شطرًا لا بأس به من الكتّاب.
بين هبة رؤوف عزت وغيردا ليرنر
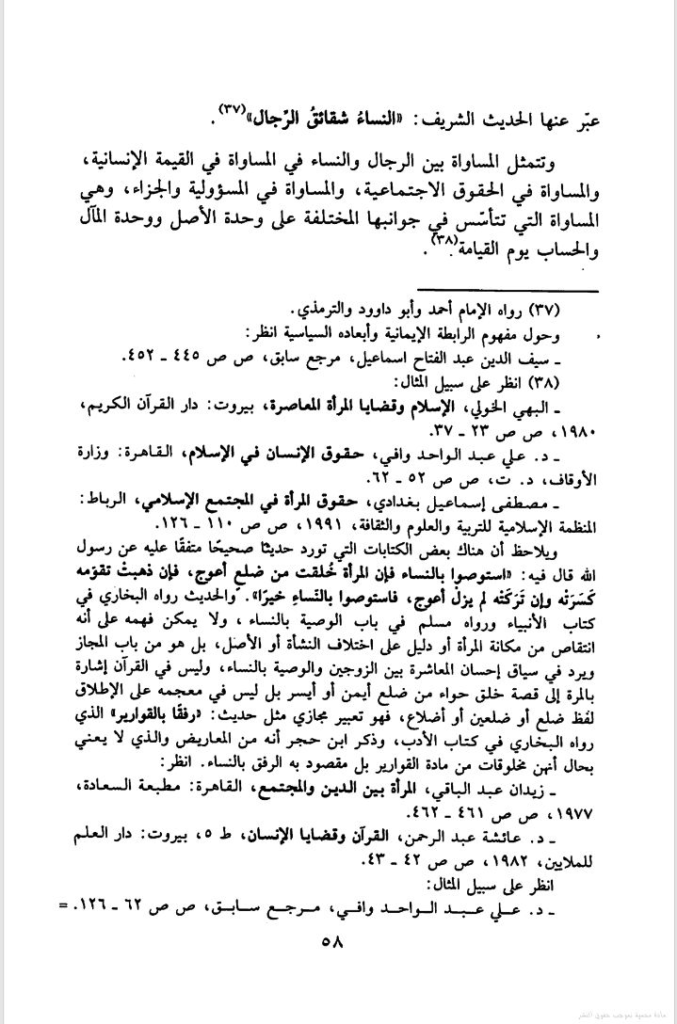
هذا النص أصله مطروح في كتاب نشأة النظام الأبوي لغيردا ليرنر، وهو متراوح -في استلال آلية التأويل- بين دراسات للاهوتيات نسويات يهوديات، بداية من راشيل سبيغت ١٦١٧، سارة غريمكي ١٨٣٨، فيلبس تريبل، فيلبس بيرد ١٩٧٤، أيضا وجون كيلفن ١٨٤٨، ودايفيد فريدمان ١٩٨٣.
لست بصدد تفصيل قانون التأويل المعتمد في كل دراسة، بحسب سرد غيردا ليرنر، ومقارنة بذلك بما قدمته هبة رؤوف هنا، فليست المنشورات محل ذلك. لكن حسن التنبيه -اللطيف- حول مركزية تأويل «الخلق من الضلع الأعوج» لتأكيد وحدة الأصل، الذي يؤسس فيما بعد لفكرة “المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الاجتماعية، والمسؤولية”.
هذه الورقة، لهبة رؤوف، مع شفط بعض الدهون عنها، تظهر -إذا ما قورنت بنصوص من ذكرتهم أعلاه ممن أسسوا لضرورة تأويل قصة الخلق من ضلع أعوج- أنه لن يكون بينها وبين تلك الدراسات فرق، سواء كان في الأداة، في التأويل، في الأدلجة، في التوفيد، في الاستنساخ أيضا. غيردا ليرنر، سمت كل منهم، على أنه مارس «عملية تأويل نسوية» 36
غيردا ليرنر والمسألة الماركسية
غيردا ليرنر -وكثير من النسويات- يختزلن دائما النسوية الماركسية، في صورة أنجلز أو تروتسكي، ودوما ما تأتي مركزية كتاب «أصل العائلة» لأجلز، ويتم تحميله عبوَّات تحررية منفلتة، مثلًا تقول لينر عن أنجلز: “إذا كان سبب استعباد النساء هو تطور الملكية الخاصة والمؤسسات التي نشأت عنها، إذًا، يتبع، منطقيا، أن إلغاء الملكية الخاصة سيحرر النساء” 37
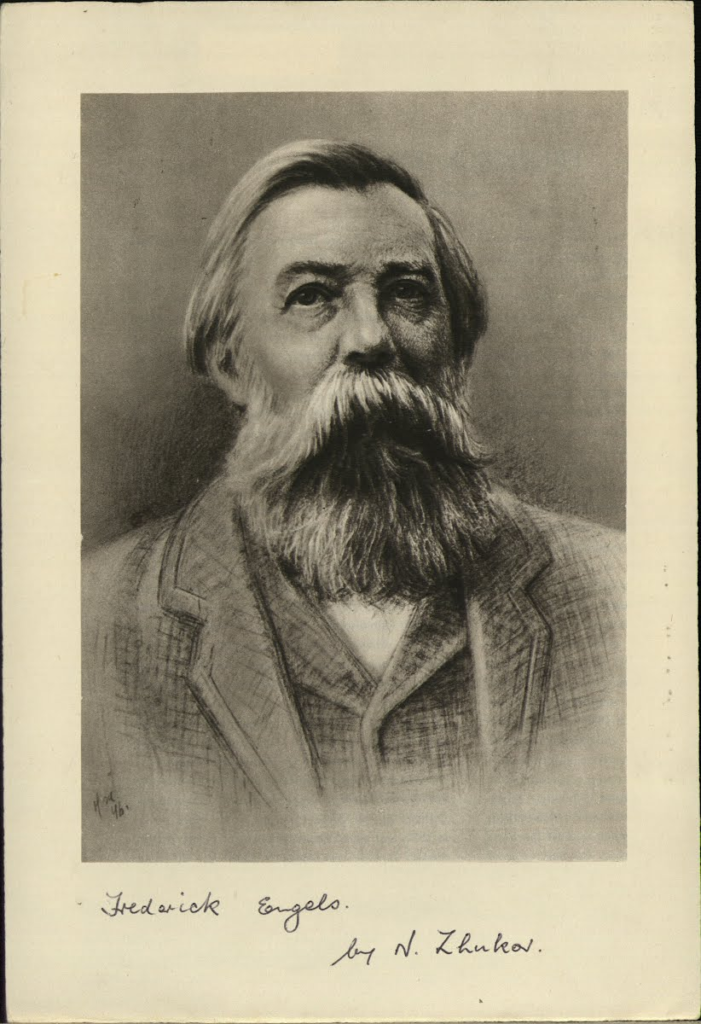
إلغاء الملكية سيحرر النساء من ماذا بالضبط؟ تذكر لينر عن أنجلز كلمة أنه بعد “الإطاحة بحق الأم، صارت المرأة عبدة رغبة الزوج جنسيًا ومجرد أداة لإنتاج الأطفال” 38 هنا نحن أمام إشكال الاتساق تجاه هذا الزعم، نحن نعيش -أو بالأحرى العالم الغربي يعيش- شيوع ثقافة الملكية الخاصة، فهو عالم رأسمالي أساسا، لا هو إشتراكي، ولا هو رجعي.
ومع ذلك تتقدم النساء الغربيات في عالم الملكية الخاصة، نحو عدم [الاستغلال الجنسي] في مؤسسة العائلة، ويتلاءم ذلك مع المؤسسة القانونية، كما تتقدم نفس النساء بوتيرة متسارعة نحو تعديل إنتاج الأطفال أو الحد منه، وتلعب شركات إنتاج حبوب منع الحمل دورًا رئيسيًا، إلى جانب البروباغاندا الإباحية الداعمة لثقافة السحاق.
إذًا، الملكية الخاصة والرأسمالية لا تعبر عن وسيلة مركزية -تاريخيا- في إخضاع النساء، إذ هي اليوم: وسيلة مركزية لتحررهن التام، إشتراكيًا، النساء والرجال يساهمان معا في إنتاج الأبناء، كما يساهمان معًا في المسألة الجنسية، والزواج الأحادي حسب تعبير إنجلز لا يعبر -اشتراكيا- عن ملكية خاصة وبالتالي: خطأ، بل يمثل «حصرية عاطفية» على الطرفين، ولذلك كان لينين يعادي نزعة «الحب الحر» التي تمظهرت في علاقة الماركسيان سيمون ديبوفوار، وسارتر، ويعتبرها مطلبًا ذا أسس رأسمالية.
المراجع
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٣٥. ↩︎
- المرجع السابق نفسه. ↩︎
- المرجع السابق نفسه. ↩︎
- حسب إحصائيات اليونيسكو، ٢٠٠٩. ↩︎
- خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة، ٣٥١. ↩︎
- المرجع السابق نفسه. ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٢٦ ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٢٨ ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٢٨ ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص29 ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص30 ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص30 ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص30 ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٥٢ ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٥٣. ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا لينر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٦٦ ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٧٣. ↩︎
- المرجع السابق نفسه بتصرف يسير ↩︎
- المرجع السابق نفسه ↩︎
- ميشيل روسلو، ضمن: نشأة النظام الأبوي، ص٧٣ ↩︎
- المرجع السابق نفسه. ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٨٧. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٨٨. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٨٨. ↩︎
- أيضا ذي نفس نظرية دوركاييم حول نشأة الدين. ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٨٣. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص١٠١. ↩︎
- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث،محمد الغزالي، ص٣٣. ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص١٠٢. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص١٠٣. ↩︎
- خمسة آلاف عام من الأنوثة العراقية، مطر سليم، ص١١٣. ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٢٠٠. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٢٠١. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٢٠١. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٢٠٢، بتصرف يسير. ↩︎
- نشأة النظام الأبوي،غيردا ليرنر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٣٦٤- ٣٦٦ ↩︎
- نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر، ترجمة: أسامة إسبر، مركز دراسات الوحدة العربية، ص٥٩. ↩︎
- المرجع السابق نفسه، ص٦٠. ↩︎
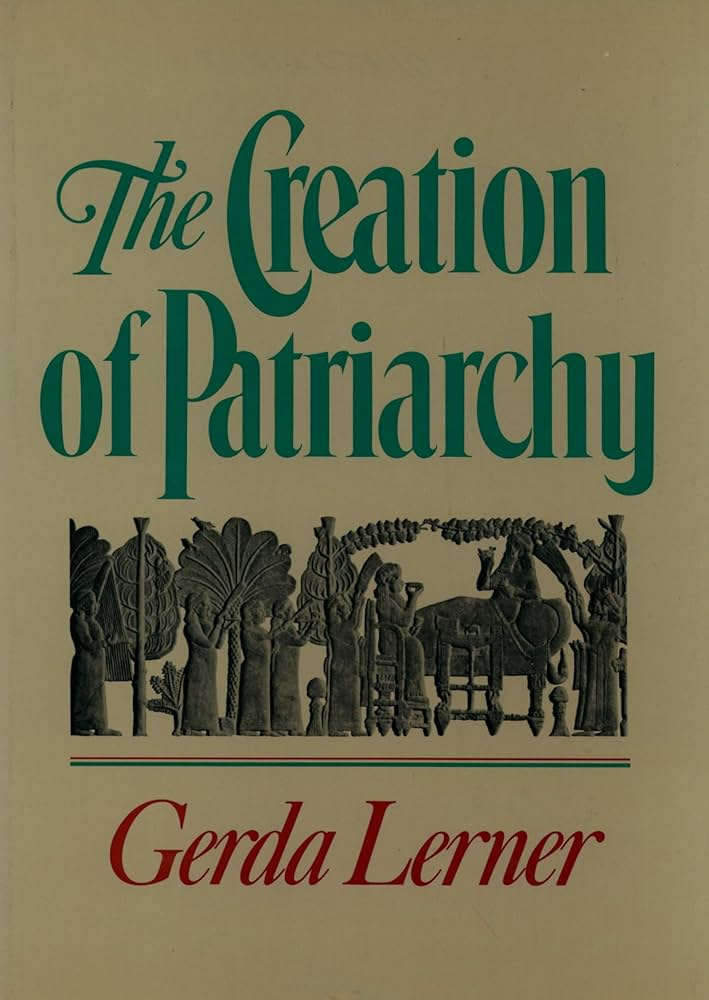

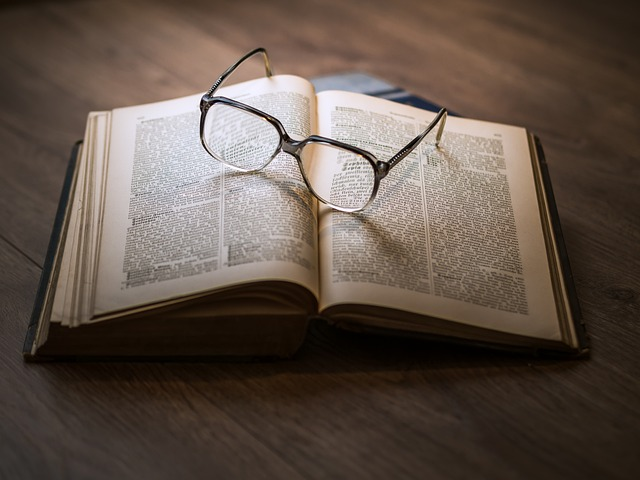
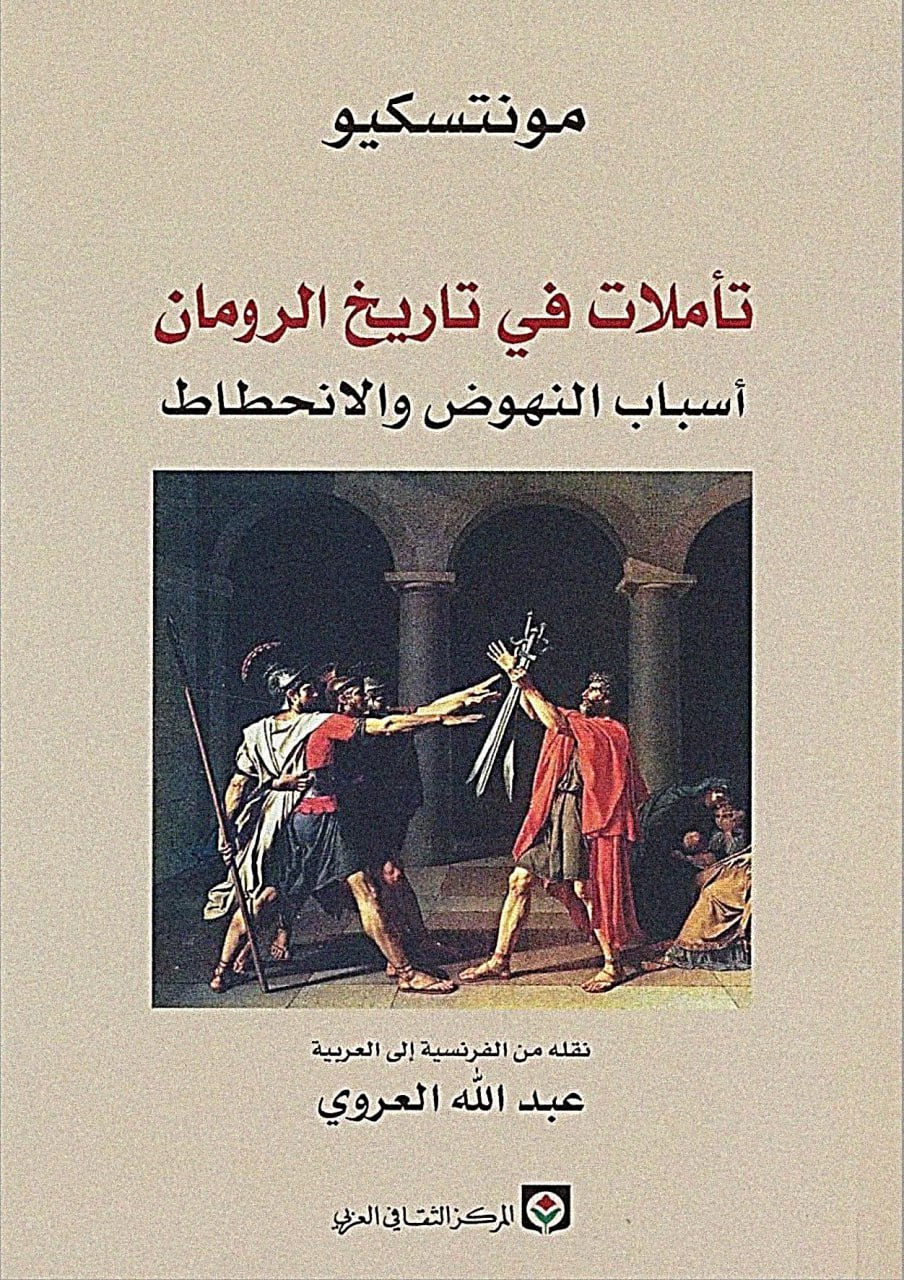
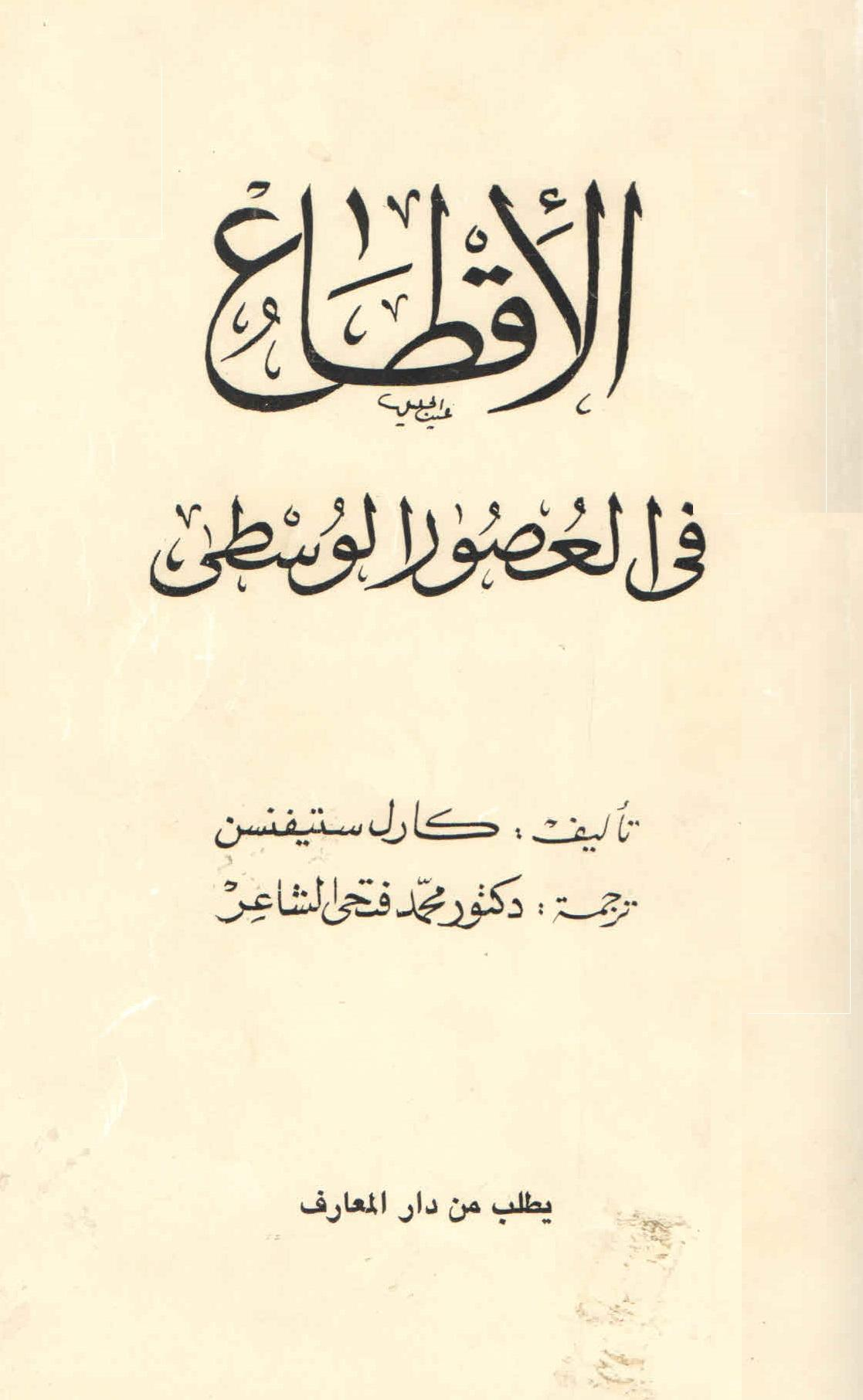
اترك تعليقاً